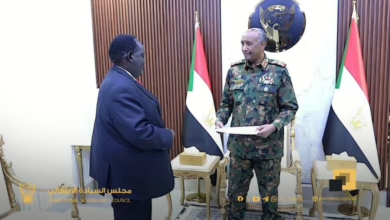(وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السابق)
مقدمة:
تكتسب مبادرة السيد/ رئيس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام) أهمية قصوى، وإن جاءت متأخرة، بل ومتأخرة جداً. أهمية هذه المبادرة تكمن في أنها أتت من رأس السلطة التنفيذية للنظام الانتقالي لثورة ديسمبر المجيدة والذيأمضى سحابة العامين الماضيين محاولاً تدوير الزوايا على أمل الوصول بسفينة الفترة الانتقالية إلى بر الأمان، حسب تقديره. كما هو معلوم فإن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها مبادرات أخرى هامة مثل مبادرة “ميثاق العودة الي منصة تأسيس ثورة ديسمبر المجيدة“ في 25 أبريل من العام الحالى، والتي تقدم بها نفر كريم من أبناء الوطن، على رأسهم الأستاذ محجوب محمد صالح راعى المبادرة. هناك أيضاً مبادرة “العقد الاجتماعي الجديد“، وهى أيضاً مبادرة هامة وسبَاقة طرحها حزب الأمة في 26 مارس 2020، وتحدث عنها باستفاضة الإمام الراحل، طيب الله ثراه. إلا أن مبادرة رئيس الوزراء، لا مشاحة، تكتسب أهمية قصوى لأنها بمثابة اعتراف بفشل بل وإفلاس نهج الترضيات و”البراغماتية” المرسلة الذى كان ديدن رئيس الوزراء في التعاطي مع الفاعلين في سوق السياسة الانتقالية المتلاطم والمتنافر الرؤى والأهداف، الأمر الذى، لا شك، أضعف من عنفوان وتماسك “الفعل الثورى” الذى أتى بهذه الثورة المجيدة، فضلاً عن تعطيل إنفاذ مشروع الإصلاح الاقتصادى وإعادة بناء مؤسسات الدولة السودانية. لكن الآن تغير كل شيء بعد هذه المبادرة فالرسائل التي توجه بها رئيس الوزراء للشعب والتي أراد إيداعها في بريد كل “من يهمه الأمر” تشير بوضوح إلى أن هناك “نقلة نوعية” ومفارقة جذرية للنهج الذى تبناه خلال الفترة السابقة. نأمل أن تكون هذه القراءة صحيحة وأن تتحقق في مقبل الأيام.
المبادرة في السياق التاريخي لمعضلة “المتلازمة السودانية”:
خصصت مجلة النيويورك تايمز الواسعة الانتشار صفحة الغلاف في 23 فبراير، 1953 لدولة السودان التي كانت تتهيأ للاستقلال من الحكم الاستعمارى، حيث وصفت بلادنا الحبيبة بأنها “نقطة مضيئة في قارة مظلمة“. لم يكن هذا التفاؤل بمستقبل السودان مستغرباً وقتها بالنظر للتجربة السياسية المتميزة والإمكانات البشرية والمؤسسية التي كانت متاحة للبلاد عند فجر الاستقلال منذ أكثر من 65 عاماً. إلا أن السودان، ولأسباب لم يعرها المراقبون ولا حتى الآباء المؤسسون الاهتمام الكافى، قد أصبح يُعرًف بأنه بلد الحروب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي والفشل التنموى. كما هو معلوم، لقد شهدت البلاد حتى الآن ثلاثة أنظمة استبدادية متطاولة أسقطتها ثلاث انتفاضات شعبية (في أعوام 1964 و1986 و2018-2019، على التوالى). أفرزت الأوليتانمنها ديمقراطيتين قصيرتى الأجل، بينما أدى زوال آخر نظام استبدادي، كما كان من قبل، إلى تشكيل السلطة الانتقالية الحالية. لهذا فقد دُرج على توصيف التاريخ السياسي للدولة السودانية المستقلة بأنه تأريخاً مأزوماً يتمثل في ظاهرة “المتلازمة السودانية”: وهى عبارة عن سلسلة زمنية تبدأ بنظام شمولى فاشل (نزاعات أهلية، تبديد للموارد وتخلف اقتصادى)، تسقطه ثورة شعبية (انتقال ديموقراطى هش وقصير العمر وتواصل الحروب والأزمات)، ثم نظام شمولى جديد … وهكذا.
أود هنا أن أقتطف باستفاضة فقرات من حوار أجرته معى صحية التيار الغراء بتاريخ 15 فبراير من العام الحالى وذلك لعلاقتهبتوصيف الحالة السودانية الماثلة:
“حالة السودان الآن يمكن توصيفها في إطار نظرية ما يسمى ب “الممر الضيق نحو التطور والحرية” والتي تناولها كتاب صدر في العام 2019 لأثنين من أساتذة الاقتصاد السياسى ذائعى الصيت (دارون أسيموقلو، معهد ماساتشوتس للتكلنوجيا؛ وجيم روبنسون، جامعة شيكاغو). حسب هذه النظرية، ربما قد يكون السودان قد دخل في هذا الممر كنتيجة للطاقة التعبوية الشعبية الهائلة التي أفرزتها ثورة ديسمبر المجيدة، مما أدى إلى الإطاحة بنظام شمولى، مجرم وباطش وإحداثِ قدرٍ من التوازن بين قوة المجتمع وقوة النخبة الحاكمة الحالية خلال هذه الفترة الانتقالية. إلا أن الممر نحو الحرية والتطور يظل ضيقاً جداً بالنظر إلى أن الحكم الانتقالى قد ورث من النظام البائد واقعاً مأزوماً بكل المقاييس، مما يعنى أن الخروج من هذا الممر والردة نحو الشمولية أو الفوضى يظل، للأسف، هاجساً قابلاً للحدوث. وقد حدث هذا في السابق بعد ثورة أكتوبر، 1964 وانتفاضة مارس/أبريل، 1985، والذى يمكن توصيفه ب “المتلازمة السودانية” أو “الحلقة المفرغة”. بحسب هذه النظرية، في الغالب أسباب تعرض المجتمعات لهذه الكارثة الماحقة (أي الخروج من الممر الضيق) تتلخص في ثلاثة مشاكل تعصف بالفترة الانتقالية أو فترة ما بعد الاستحقاق الانتخابى: حرب أهلية، أزمة اقتصادية أو سياسية خانقة؛ انقسامات حادة وتشرذم مجتمعى؛ وغياب محكٍم لمعالجة التباينات والخلافات بين مكونات المجتمع. وفى هذا السياق يحضرنى مقالين لأثنين من رجال الفكر والسياسة المرموقين. فقد حذر دكتور إبراهيم الأمين في مقال صحفى مقتضب عن أن “الذهنية التي يتم التعامل بها مع قضايا البلاد الخطيرة والمعقدة عقيمة ومتخلفة، ونحن للأسف في حالة صراع مستمر دون أن نلتفت لما يترتب عليه من تبعات، يحدث هذا بعد ثورة شهد العالم بعظمتها وتفردها، مع ذلك اختلطت الأوراق وتداخلت الأحداث وتصاعدت الخلافات بين مكونات الحرية والتغيير بصورة خطيرة يسعى كل طرف إلى تعظيم مصالحه وإن تعارضت مع المصالح العليا للبلاد. شباك منصوبة يريد كل منهم أن يحقق عبرها أكبر قدر من الخسائر للآخر دون أن يدرى أن الخاسر الأكبر هو الوطن.” أما المقال الآخر، للأكاديمى بروفسور مهدى أمين التوم، فقد كان بحق “صيحة في وادى الثورة”، كما أسماه، حيث خاطب كل القوى السياسية والمهنية وحركات الكفاح المسلح والقوات النظامية بضرورة العمل المشترك ونبذ التخندق في المواقف والأجندات الضيقة.“
وبعد هذه المقدمة التحليلية واستعراض ما تفضل به دكتور إبراهيم الأمين وبروفسور مهدى أمين التوم، طرحت التساؤل التالى في ختام هذا الجزء من المقابلة الصحفية:
“فهل يا ترى ستقوم هذه الحكومة ببذل أقصى ما تستطيع لمعالجة الأزمات التي تحيط بنا من كل حدب وصوب وهل سينهض “مجلس الشركاء” بدوره، كمحكٍم، لبناء تحالف قومى عريض لاحتواء الخلافات والتباينات الماثلة والمتوقعة بين مكونات الحكومة وقواعدها المجتمعية وبينها والمعارضة، حتى نستطيع البقاء في داخل هذا الممر الضيق المتاح لنا الآن بفضل هذه الثورة المجيدة والعبور إلى إلى آفاق التطور والحرية المستدامة.“
تأسيساً على ما دار في مقابلة صحيفة التيار، أقول بأن مبادرة السيد رئيس الوزراء تكتسب أهمية قصوى لأنها تلامس الإشكالية التاريخية المترتبة على “المتلازمة السودانية”. لهذا لابد من إيلائها الاهتمام المستحق من حيث التحليل والنقد الموضوعى البناء بهدف تطويرها ودعمها وهذا ما سأسعى إليه فيما تبقى من هذا المقال.
المواقف وردود الأفعال:
دعنا نحاول الآن مقاربة ردود الأفعال على المبادرة بناءً على المواقف المعلومة للقوى السياسية من السلطة الانتقالية والأجندة الوطنية الماثلة. برأى أن هناك ثلاثة معسكرات ذات مواقف سلبية أو غير بناءة لجهة دعم وتصويب المبادرة.
أولاً، هناك معسكر اليمين “المغبون”، الذي قطع بأن المبادرة تؤكد ما ذهب إليه من أن النظام الانتقالي قد فشل فشلاً ذريعاً ولا ينتظر منه الخير للسودان وعليه يجب أن تذهب السلطة الانتقالية بشقيها المدنى والعسكرى اليوم قبل غدٍ وأن يصار إلى انتخابات فورية ترد الأمر إلى الشعب. هذه دعوة حق أُريد بها باطل، بالنظر إلى أن الانتقال الديموقراطى المستدام يتطلب ترتيبات، تبدأ بإكمال مشروع السلام، عودة وإعادة تأهيل النازحين واللاجئين وغير ذلك من الترتيبات مثل سن التشريعات اللازمة وإجراء التعداد السكانى …إلخ. المغازى السياسية الهدَامة لهذه الرؤية معلومة، بالرغم من أن استسهال تمديد الفترة الانتقالية من قبل تحالف السلطة الانتقالية الحاكم، كما سنوضح أدناه، أيضاً لا يقل خطورة على البلاد والثورة من مؤامرات ما تبقى من طغمة الاسلامويين وأشياعهم من شركاء النظام المباد.
ثانياً، المعسكر الثانى يشمل أطرافاً من اليسار السودانى بقيادة الحزب الشيوعى والذى لم يخفى أن هدفه الاستراتيجي “لتحقيق العدالة ورفض الغلاء والزيادات في الأسعار والقصاص للشهداء، ومواصلة تراكم المقاومة الجماهيرية” يتطلب إسقاط ما أسماه “شراكة الدم وقيام البديل المدني الديمقراطي، وتحقيق أهداف الثورة”. لا شك أن الحزب الشيوعى يمثل تياراً وازناً في السياسة السودانية، ولا شك أيضاً أن هناك مطالباً مشروعةً، بل وهامة جداً، تبناها الحزب مثل تصويب عملية السلام واعتماد معايير واضحة تضمن استقلالية القضاء وإعادة بناء الأجهزة العدلية على أسس من الشفافية والكفاءة …إلخ. إلا أن كل المؤشرات تشى بأن مشروع الحزب بشأن إسقاط الحكومة عن طريق عمل جماهيرى تعبوى لا يعدو بأن يكون في أحسن الأحوال فعلاً “دونكيشوتياً” مربكاً للحالة السودانية القلقة أصلاً. وحتى في حالة نجاح مظاهرة 30 يونيو في تعبئة ثقلٍ جماهيريٍ هائلٍ، وهذا مستبعد على كل حال، فسوف لن يؤدى ذلك إلى تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة في ظل الاستقطاب الحالي. لعل من المفيد التذكير بأن نجاح الثورة قد تحقق عن طريق “فعلٍ ثورىٍ” غير مسبوق، حيث شهدت الفترة من مارس 2018 إلى مارس 2019، أكثر من 150 مظاهرة كبرى في العاصمة وحوالى 25 مدينة وبلدة على امتداد جغرافيا الوطن الحبيب. أيضاً، كما هو معلوم فإن تحالف الحرية والتغيير قد جسد إجماعاً سودانياً منقطع النظير، انحازت له القوات المسلحة السودانية بكافة أفرعها. إذن، أي عمل ثورى منفرد، إذا قُدِر له أن يتعدى الدونكوشتية الثورية، قد يشكل معبراً لردة شمولية تعيد إنتاج “المتلازمة السودانية”- ثورة عظيمة تفضى لنظام ديموقراطى مبتسر تعقبه شمولية مدمرة ومتطاولة. بل، فإن هشاشة الحالة السودانية الحالية تنذر بما هو أسوأ، لا سمح الله. وقديما قال زهير ابن أبى سلمى محذراً قومه:
وَمَا الحَـرْبُ إِلاَّ مَا عَلِمْتُمْ وَذُقْتُـمُوَمَا هُـوَ عَنْهَا بِالحَـدِيثِ المُرَجَّـمِ
مَتَـى تَبْعَـثُوهَا تَبْعَـثُوهَا ذَمِيْمَـةًوَتَضْـرَ إِذَا ضَرَّيْتُمُـوهَا فَتَضْـرَمِ
فَتَعْـرُكُكُمْ عَرْكَ الرَّحَى بِثِفَالِهَـاوَتَلْقَـحْ كِشَـافاً ثُمَّ تُنْتَجْ فَتُتْئِـمِ
فَتُنْتِـجْ لَكُمْ غِلْمَانَ أَشْأَمَ كُلُّهُـمْ كَأَحْمَـرِ عَادٍ ثُمَّ تُرْضِـعْ فَتَفْطِـمِ
دعونا أيضاً ومن موقع العشم وبكل تواضع، آملاً أن يتسع صدر القادة والكوادر الوطنية في هذا الحزب العريق، لبعض الأسئلة التي أود أن أطرحها عليهم كمواطن سودانى بشأن البرنامج الاقتصادى:
في ختام هذا المحور، أتمنى وبكل صدق، بأن يصبح الحزب الشيوعى السودانى يوماً ما من قادة وحداة مشروع دولة “الديموقراطية الاجتماعية” وأن يساهم في بناء رؤية تقدمية لدور الدولة كقائدة للتنمية وداعمة لمشروع “الحماية الاجتماعية الشاملة” وأيضاً “كناظمة” لمساهمة القطاع الخاص الوطنى والأجنبى في اقتصاد حديث يستشرف الثورة الرقمية ويستند إلى طبقة عاملة شابة ذات إنتاجية عالية، تماماً كما فعل رصفاؤه في الصين وفيتنام وأتباع سلفادور أليندى في التشيلى.
ثالثاً، أخيراً تأتى مواقف أحزاب قحت وحركات الكفاح المسلح المشاركة في حكومة ما بعد اتفاق جوبا والتي اتسمت بالتأييد شبه المطلق للمبادرة، الأمر الذى يعكس الارتياح الكامل لهذه القوى بما كسبوا من أدوار ومسئوليات، ونسارع لنقر بأن هذا حقهم. إلا أن الشعب السودانى، برأى، كان ينتظر منهم تقييماً صارماً ومسئولاً في إطار مسئولياتهم الوطنية والسياسية، يساهم في تصويب وتكملة هذه المبادرة.
مقترحات لتعزيز المبادرة:
ولكن ربما يرى البعض بأن هذه المبادرة شاملة بما يكفى، فما هي إذن القضايا والمحاور التي يتوجب تضمينها في المبادرة؟ كمساهمة متواضعة في الحوار الوطنى الذى يتوجب أن يستتبع هذه المبادرة، أود مناقشة خمس قضايا جوهرية برأى يمكن أن تساهم في تطويرها وتعزيز الدعم الشعبى لها.
أولاً، هذه المبادرة تحتاج إلى “محكٍم” يحظى بقبول معظم أطراف الحركة السياسية والمجتمع المدنى وحواضنهما الاجتماعية والشعبية، إضافة إلى قيادة المؤسسة العسكرية، لأنها تهدف لمعالجة قضايا شائكة وبالغة الحساسية، مثل مراجعة أسس “المساومة” التاريخية التي أٌبرمت في يونيو 2019 بين تحالف الحرية والتغيير وقيادة القوات المسلحة (الجيش السودانى والدعم السريع) وحسم قضية جريمة فض الاعتصام، بما يضمن تحقيق العدالة وغير ذلك من القضايا التي لم تشملها المبادرة، كما سنبين أدناه. كما أوردنا أعلاه، عدم وجود هكذا محكم في ظل التشظى والأزمات التي اعتورت فترات ما بعد ثورة أكتوبر وانتفاضة مارس-أبريل كانت من أسباب الردة الشمولية التي أخرجت البلاد من ذلك “النفق الضيق” المفضى إلى الديموقراطية والتنمية المستدامة. على سبيل المثال، التفاؤل الذى يبديه معظم المراقبين بشأن مآلات الثورة التونسية يعود إلى الدور الوطنى الهام الذى يضطلع به “الاتحاد العام للشغل التونسى“، كمحكم بين أحزاب البرلمان ومؤسسة الرئاسة. هذا الاتحاد يحظى بتقديرٍكبيرٍ في تونس بالنظر إلى استقلاليته وحياده السياسى، إضافة إلى سجله الحافل على مدى أكثر من 75 عاماً من النضال ضد الاستعمار والدفاع عن حقوق الطبقة العاملة التونسية، منذ تأسيسه في يناير 1946. للأسف نحن ليس لدينا محكماً مؤسسياً بهذه المواصفات في السودان، ولكن لدينا أصحاب مبادرة “العودة الي منصة تأسيس ثورة ديسمبر المجيد“، وهم شخصيات وطنية وازنة وجديرة بأن تلعب هذا الدور. لعل الكلمات المعبرة التي اختتموا بها مذكرتهم الضافية تبعث فينا بعض الأمل والتفاؤل إذا قدر لهذا النفر الكريم أو بعضهم بأن يتصدوا لهذه المسئولية الوطنية الجسيمة:
“إنها فرصه تاريخيه للعودة للوحدة ولنقطه التأسيس ليعود للثورةألقها، وللشعب أمله وثقته في مكوناته السياسية والمجتمعية، ويحي تطلعه لغد يستحقه الوطن، ويتناسب مع ما تم بذله من تضحيات وما أُريق من دماء في ثوره ديسمبر المجيدة”.
ثانياً، مشروع بناء السلام أولوية وطنية قصوى لا جدال في ذلك. إلا أن آليات تحقيق السلام ولأسباب عملية وبراغماتية قد حصرت استحقاقات اتفاقيات السلام، بما في ذلك قسمة السلطة، في إطار ثنائى بين الحكومة المركزية وحركات الكفاح المسلح. عليه، من الأهمية بمكان تأمين مشاركة واسعة لكل مكونات الأقاليم المتأثرة بالنزاعات، ليس فقط في إطار “قسمة السلطة الشاملة: inclusive power-sharing” في المركز، بل وخاصة في إطار قسمة “السلطة التوزيعية: dispersive power-sharing“ في الأقاليم. لتحقيق هذا الهدف المحورى لابد من أن يصار إلى عقد مؤتمر قومى للسلام، يهدف أيضاً إلى إضفاء المزيد من الشرعية الشعبية والمرجعية القومية اللازمة لتحصين مشروع السلام، والذى لابد من الإقرار بانه قد تم تصميمه وإنجازه على أساس الشرعية الثورية وبراغماتية الأمر الواقع، المنسحبة على طرفى التفاوضعلى حدٍ سواء. في هذا السياق تفيد تجارب أكثر من 40 اتفاقية لقسمة السلطة منذ الحرب العالمية الثانية إلى أن اقتسام السلطة على المستويين الشامل والتوزيعى، إضافة إلى دمج القوات، قد ساهموا بفعالية في تحقيق السلام والانتقال الديموقراطى المستدامين، ولكن فقط في حالة توفر ثلاثة شروط رئيسة:
إذن، لابد من مؤتمر قومى للسلام لضمان استصحاب الأهداف أعلاه في إطار عملية السلام.
ثالثاً، لابد أن تستهدف المبادرة الوصول إلى توافق حول عمر الفترة الانتقالية، لأن شرعية الفترة الانتقالية نفسها تستند إلى كونها انتقالية، مرهونة بقيد زمنى محدد سلفاً حسب “الوثيقة الدستورية” كمرجعية دستورية لهذه الفترة. صحيح أن قصر الفترات الانتقالية السابقة التى أعقبت الثورتين السابقتين لم يمكن معه بناء السلام أو تهيئة المسرح السياسى بالقدر الكافى لضمان الوصول إلى انتقال ديموقراطى يمكن أن يحظى بقدر من الاستدامة. بالمقابل، فإن استخدام مشروع السلام “كحصان طروادة” لتمديد الحكم الانتقالي واستسهال انتهاك الوثيقة الدستورية كما يحدث الآن، ربما يندرج في المخططات المفضوحة لبعض شركاء السلطة الانتقالية لتأسيس “شمولية” الأمر الواقع الانتقالية، مما يشكل خطراً داهماً على الثورة والانتقال الديموقراطى، بل وعلى استدامة مشروع السلام نفسه. هذا التوجه لا يقدح في الالتزام بمشروع بناء السلام الحالي، رغم أي تحفظات أو ملاحظات هنا وهناك. وبالتالي يجب أيضا تحمل استحقاقات بناء السلام وإعادة الإعمار للأقاليم والمناطق التي تأثرت بالنزاعات. السلام استحقاق هام للخروج من “المتلازمة السودانية” العدمية. بالمقابل فإن بناء السلام لا يجب أن يكون على حساب الانتقال الديموقراطى، بل يجب أن يكون لبنته الصلبة. في الواقع تحديد قيد زمنى ملزم سيشكل دافعاً لتحريك عملية السلام، خاصة عندما يتم إكمالها في إطار مؤتمر قومى للسلام يتم عقده في الموعد المضروب وبمن حضر.
رابعاً، المشروع الوطنى للدولة السودانية لابد أن يستند إلى أحزاب مؤهلة تنظيمياً وبرامجياً، لأن وجود هكذا أحزاب ضرورة لبناء نظام ديموقراطى قابل للحياة والاستدامة. في هذا السياق يجب أن تسعى حركات الكفاح المسلح، وحتى بعض قادة المؤسسة العسكرية من الممسكين بأعنة السلطة الحالية ويرغبون في مواصلة مشوارهم الوطنى، إلى تأسيس أحزابهم أو الانضمام الى الأحزاب القائمة والاستعداد للانتقال من حالة “الشرعية الثورية” إلى “الشرعية الانتخابية”. كما ذكرنا آنفاً، من الأهمية بمكان أن تسعى الأحزاب وحركات الكفاح المسلح لبناء تحالفات بناءة فيما بينها كروافع لاستدامة مشروع السلام والانتقال الديموقراطى. من المثلج للصدر في هذا السياق خطوات إعادة بناء تحالف نداء السودان، والذى يمكن أن ينهض عليه وما يستتبعه من تحالفات مماثلة مشروعاً وطنياً يضم الأحزاب التاريخية وحركات الكفاح المسلح الناهضة. عليه، من أهم موجبات المشروع الوطنى للمبادرة أن تتحلى الأحزاب والحركات برؤية بعيدة المدى تتعدى الشغف البين بعَرَض الفترة الانتقالية إلى رحاب الديموقراطية “العائدة، الراجحة”، كما بشرنا الإمام الراحل قبل 30 عاماً وهو في غياهب سجون نظام الإنقاذ المباد، عندما دب اليأس في النفوس وبلغت القلوب الحناجر. بالمقابل، حسناً فعلت السلطة الانتقالية، وان يكن بعد تباطؤٍ وتلكؤ، في الاستعداد لإطلاق مشروع التعداد السكانى وعليها أن تسعى دون إبطاء لتوفيق أوضاع النازحين واللاجئين وتكوين المفوضيات والتشريعات اللازمة للعملية الانتخابية.
خامساً، هذه المبادرة ينبغي أن تسعى لتقييم الحكومة الانتقالية كمؤسسة من حيث توزيع الصلاحيات والمشاركة في اتخاذ القرارات وإنفاذها. برأىِ، إن أسلوب إدارة الحكومة وتمركز السلطة بصورة مخلة في مكتب رئيسها قد ساهم في تباطؤ الأداء وتحجيم المبادرات على مستوى الوزارات، بينما أثر الإغراق فى المسائل التفصيلية سلباً على قدرة رئيس الوزراء على الإشراف الاستراتيجي على الحكومة. لا داعى للخوض في التفاصيل،ولكن هناك ما يكفى من الشواهد لتبرير مراجعة شاملة لأداء الحكومة على المستوى المؤسسى الشامل وليس فقط على مستوى أداء الوزراء.
والله من وراء القصد.
29 يونيو 2021